ثمةُ أشياء يتوقعها
القارئ مني في ضوء قراءته للعنوان الذي وسمت به هذه القراءة:
·
أول هذه الأشياء هو أن ثمة مقاربة نظرية مستفيضة حول "الدال
الرياضي" لغةً واصطلاحاً سوف تدشن الدخول لتلك القراءة.
·
وثانيها أن هذه الدراسة تتوكأ على منهجٍ علميٍ ذي فروضٍ ونظرياتٍ
محددة يمكن تطبيقه عملياً في مقاربة النص الشعري من منظور رياضي بحت.
وللخلاص مما تفرضه تلك
التوقعات وأسئلتها النظرية المعتقة في إسار المنهج وغاويات التنظير، نقول:
·
إن ما تسعى إليه هذه القراءة هو فقط الإجابة غير المباشرة - في إطار
تجريبي أولي- على سؤالين محددين هما:
1-
إلى أي حد يمكن الاستفادة من المحمول الرياضي/ الرقمي/ الحسابي/
الهندسي/ الطبيعي( نسبة إلى علم الفيزياء) لعدد من المفاهيم والمفردات السائدة في
العلوم البحتة مثل مفاهيم( السقوط، والانعكاس ، والانكسار والدالة والمتغير
والمتوالية) في تدشين و إثراء المنظومة الدلالية للخطاب الشعري؟.
2-
وإلى أي مدى يمكن استعارة ظواهر طبيعية بعينها في تدشين وبناء
الخطاب الشعري ومن ثم النقدي؟"
·
إن إرضاء غرور المنهج و البحث المؤسس على النظريات والفروض التي
تحققت عملياً، أو يمكن لها أن تتحقق عملياً لا يصب - في بعض الأحيان- إن لم يكن في
معظمها- في مصلحة التجريب والمقاربات الأولية التي تعد اللبنات الأولى في بناء
النظريات والمناهج التي تأتي لاحقاً مؤسسةً على ذلك التجريب وتلك المقاربات
الأولية.
لذا سنكتفي- هنا –
بالقول الموجز: إن ما نقصده بالدال الرياضي هنا هو كل دال يمكن حسابه على العلوم
الطبيعية المؤسسة- أصلاً- على المعادلات، والأرقام، والدوال الرياضية،
والمتغيرات الرمزية التي تتشكل منها تلك الدوال.
يستثمر الخطاب الشعري
لدى علي الشرقاوي بعضاً من الدوال المشار إليها سابقاً
لإثراء المشهد الدلالي
لديه ولفتح نوافذ أخرى في مخيلة التلقي ما كان لها ان تتفتح بغير تلك الدوال ففي
قصيدته وراء اللغة من ديوانه الوعلة(1) يحضر البعد الثالث للكلام بصفته البعد
المتخيل الذي يجب على التأويل ألا يغفله، بل لابد للتلقي أن يتخيله ويعيشه ويستثمره
في بناء فرضيته ونتائجه ومنظومته الدلالية، مثلما هو الحال في علم الهندسة و
الهندسة الفراغية التي يقع الخيال منها موقعاً أساساً في الفهم والممارسة، فكثيرٌ
من الأبعادِ التي تُكَوِّنُ الشكل الهندسي في علم الهندسة خاصةً الهندسة الفراغية
هي أبعاد متخيلة:
للكلام يدٌ ثالثة
وسبعُ رئات
وخمسُ عيون
للكلام فمٌ
يشبه الذئب في لحظة
الفتك
يغزل فتوى الجفاف
بذاكرة
تركض الآن
ما بين كان وما سيكون
للكلام كلام
تلاحقه في السراب
فقد صاغ الشرقاوي في
القصيدة السابقة مجموعة من الحقائق/ المسلمات المتخيلة التي يجب على التأويل أن
يتخذها معطىً أساساً في بناءِ منظومتِهِ الدلاليةِ المنبثقةِ من عناصر المشهد
الشعري مجتمعةً في شكل استنتاج رياضي هندسي:
فالبعد الثالث للكلام
الذي عبرت عنه دالة " للكلام يدٌ ثالثة" والرئات السبع، والعيون الخمس، والفم
المفرد الأوحد يمكن النظرُ إليها على أنها معطيات يصوغها المشهد لبرهنةِ مطلوبٍ
واحدٍ يأتي في نهاية السياق هو انتشار الكلام / التأويل في شكل توليدي انشطاري إلى
الحد الذي يصعب ملاحقته في أركان المخيلة التي بدت على اتساعها وكأنها السراب الذي
لا تدرك مسافاته. ويمكن ترسيم المشهد الاستدلالي هذا على النحو التالي:
المعطيات:
1 - للكلام
يدٌ ثالثة
وسبع رئات
و خمس عيون
2 – للكلام فمٌ
يشبه الذئب في لحظة الفتك
يغزل فتوى الجفاف
بذاكرة
تركض
الآن
ما بين كان وما سيكون
3- للكلام كلام
تلاحقه في السراب.
من
المقاطع المرقمة ( 1 ) و(2 ) و(3) نستنتج ما يلي:
أ - بما أن للكلام يداً ثالثة/ بعداً ثالثاً فهو مهيمن منتشر يتفوق على الخلق
العادي بقدرة غير عادية.
ب - و بما أن له( أي للكلام) سبع رئات [ تذكر الرقم ( 7 ) المعجز في حد
ذاته]، وخمس عيون، فهو يتمتع بقدرة غير عادية وهو أيضاً خلْقٌ غير عادي كما في(1)
يتطلب من التخيل قدرة خارقة تتمدد باتجاهه محاولة إدراك مراميه.
وبما أن له فماً، ففمه هذا يمكن أن يكون قوياً مثل فم الذئب في لحظة الفتك. كما في(
2 )
ج - وبما أنه من الخلق غير العادي، والقدرة غير العادية،فإنه يصعبُ على المخيلة/
الذاكرة إدراكه لكونها مشتتة ما تلبث ان تدرك ما كان منه حتى يعييها ما سيكون
كما في ( 2 ) أيضاً.
من ( أ ) و( ب ) و(ج ) نستنتج المآل المنشودَ من منظومةِ الدلالة:
إن الكلام من القوة والقدرة والولوج في أغشية المعنى والتخفي وراءها
والانتشار في مدى مفتوح مطلق يتماهى مع السراب بحيث يظلُ عبقرياً يتيه على التأويل
والمخيلة.
يصر الشرقاوي على اكتناه ذلك العبقري واللهاث وراءه
ليس لإدراكه فحسب، وإنما لإدراك توابعه وما يختفي وراءه:
صمتٌ قزحيٌ
كرصيف الشهوة في برق الأخضر
يدخل بين صباح المسكوت عليه
و ليل
الماء المكسور بإبهام الضوء
لهذا المتقزح في اقيانوس الرغبة
مازلت أنطُ كلحن جراد الرأس على ما بعد المعنى
لاظل كما عاش المعيوف الصاعد في بحر الوقت
بريئاً كخيال الرعد
فتياً
كسؤال النجمة قبل النطق( 2 ). ولترسيم محاولات الإدراك وما يكتنفها
من إصرار طرفها الأول ( الشاعر) ومراوغة طرفها الثاني (الكلام) استدعى
الشرقاوي دالته المستمدة من علوم الطبيعة، والمبنية على ظاهرة انكسار الضوء، تلك
الدالة التي توكأت متغيراتها على مفردات ( قزحي/ رصيف / برق/ الأخضر/ صباح/ ليل
الماء/ المكسور/ الضوء/ المتقزح/ اقيانوس.
فقد
استلهم الشرقاوي ظاهرة انكسار الضوء من علم الطبيعة ليبني منظومته الدلالية مرتكزاً
على وعي مفارق يقوم على تقنيتين:
·
اللعب في المتغيرات الأصلية لدالة الضوء
وانكساره:
ويتم
ذلك اللعب عبر استعارة تلك المتغيرات نفسها وجعلها تتجاور مع أخرى ليست من نسيجها
بالمرة، بل هي متغيرات لا تكون إلا في الوعي الشعري. فالمتغيرات:
(صمتٌ / المسكوت عليه/إبهام/ الرغبة/ الوقت/خيال/ سؤال) التي يمكن
أن تشكل منظومةً من الوعي الشعري المهادن التقليدي يحولها الشرقاوي إلى عناصر فاعلة
في منظومةٍ من الوعي الشعري المفارق المنتهك. وذلك من خلال استخدامه لهذه
المتغيرات صفاتٍ، أو مضافاتٍ، أو مضافاتٍ إليها لمتغيرات ذات صلة مباشرة أو غير
مباشرة بظاهرة انكسار الضوءِ،فتتحول بذلك الدوال المهادنة إلى دوال مفارقة منتهكة:
صمتٌ قزحيٌ / صباح المسكوت عليه/إبهام
الضوء/ خيال الرغبة/ بحر الوقت/خيال الرعد/ سؤال النجمة).
·
التوظيف الانقلابي لمعطى الظاهرة الطبيعية:
إذ لا يكتفي الخطاب
الشعري لدى الشرقاوي بالانزياح بتلك المتغيرات ، وإعادة توظيفها من جديد بغية تحقيق
المفارقة، وإنما يسعى إلى التوظيف الانقلابي لحقيقة الظواهر الطبيعية وثوابتها،
فالضوء المنكسر في الظاهرة الطبيعية يتحول إلى فاعل/ كاسر لغيره في الخطاب الشعري:
و ليل الماء المكسور بإبهام الضوء.
كما أن ظاهرة انعكاس
الضوء في علم الطبيعة تتحول في خطاب الشرقاوي إلى حالة توحدٍ مرجوٍ ( يتمنى الشاعر
تحقيقه) بين العاكس والمعكوس:
عيناها هادئةُ الأزرق
وعيوني ريشُ الضوء
الحنطاوي
لماذا
لا نتعاكسُ
كالجملةِ في اللغة
الشجراءِ
توهجني بطراوتها
و أتوجها بالحلمِ
تكون الملكة
وأكونُ فضاءاتِ العرشْ
(3)
وهذا التوحد المطلق
المرجو تحقيقه يتوخى في حدوثه تراتبية المشهد عبردوالٍ/ صور ثلاثٍ يتحقق من خلالها
التوظيف الانقلابي المفارق للظاهرة/ الدالة الطبيعية وعناصرها الفاعلة:
الدالة/ الصورة الأولى
:الضوء الساقط:
عيناها هادئةُ الأزرق
وعيوني ريشُ الضوء
الحنطاوي
الدالة/ الصورة
الثانية: جدلية الانعكاس وأفعاله المرتبطة به
لماذا
لا نتعاكسُ
كالجملةِ في اللغة
الشجراءِ
توهجني بطراوتها
و أتوجها بالحلمِ
الدالة/ الصورة
الثالثة: مشهد الاحتواء:
تكون الملكة
وأكونُ فضاءاتِ العرشْ.
ففعل الانعكاس في
الظاهرة الطبيعية يتحول – هنا- في الخطاب الشعري إلى جدلية يتقاسمها فاعلان
(نتعاكس). ثم يتحول المشهد الجدلي المفارق هذا إلى مشهد احتواء يتجاوز فيه ريش
الضوء قدرة أي فاعل على عكسه، بل يتحول (ريشُ الضوء / الشاعر) إلى فضاءات احتواء
شاسعة للحبيبة الملكة.
هذا ويظل الدال الرياضي
لدى الشرقاوي - عبر معظم دواوينه الشعرية - عنصراً فاعلاً - ضمن عناصر أخرى-
في بناء متواليات الدلالة وإنتاج شعرية المفارقة.
المراجع والهوامش
(1) ديوان الوعلة
ط 1 المنامة 1998 ص 9).
(2)
قصيدة تجميع أول ..ديوان من أوراق ابن الحوبة المؤسسة العربية للدراسات
والنشر – بيروت لبنان ط 1 2002م ص 9).
(3) قصيدة تزمر وقتي من
ديوانه كتاب الشين الصادر عن منشورات نون البحرين ط1 1998م ص 195).
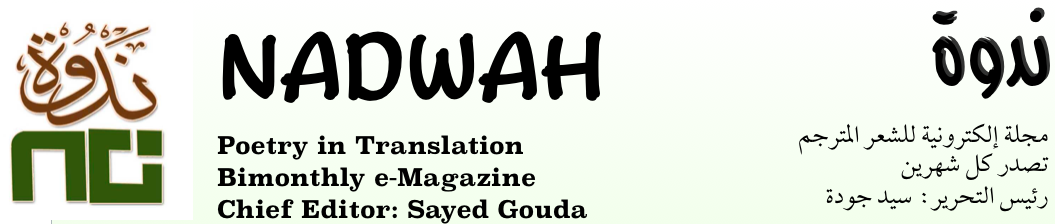 ف
ف

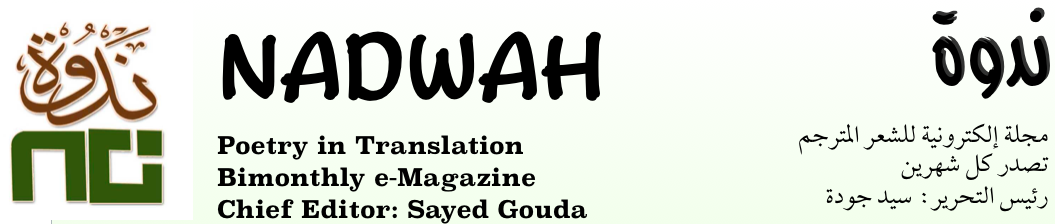 ف
ف
