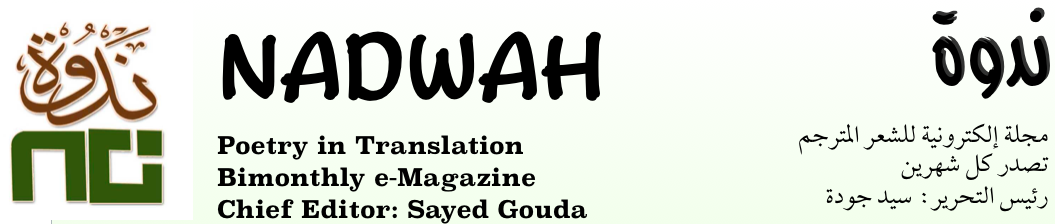 ف ف |
| شعر مترجم |
|
أحمد فضل شبلول
- مصر
من بين عشرات أو
مئات الشعراء الشباب في مصر الآن، يبرز صوت عبد الناصر أحمد
الجوهري الشعري، من
خلال ديوانه الرابع الذي اختار "لا عليكِ" عنوانا له، على الرغم
من أنه ليس أفضل
عناوين قصائد الديوان، فهناك عناوين أفضل منه، من وجهة نظري، مثل: "مرثية للعشق
الندي"، أو "رسائلك لا تحمل ختم الديوان"، أو "ردي علي
حديقتي" وغيرها. مثل هذه
العنوانين الثلاثة وغيرها كان من الممكن أن تصلح عنوانا
لديوان الجوهري، وعلى الرغم
من ذلك يبرز من خلال هذا العنوان الذي اختاره الشاعر لديوانه
"لا عليك" أغلب خصائص
الديوان، وخاصة الاتجاه الوطني أو السياسي غير الزاعق الذي
تحمله نبرة القصائد،
فالقصائد الأولى توهمنا أن الشاعر يخاطب حبيبته الأنثى من خلال
مفردات العشق والغزل
والهيام التي نجدها بكثرة في أعمال شعراء الرومانسية، مثل:
العشق واللوعة والوجد
والسهد وترانيم الليل والمواجيد وشغاف القلب واللهفة .. وما إلى
ذلك.
ولكن يتضح بعد ذلك، وبالتوغل في قصائد الديوان، أن الشاعر
يقصد بضمير المخاطب (الكاف
المكسورة في العنوان: لا عليكِ) مصر، أي أنه يقصد لا عليكِ يا مصر، وهنا
تتحول الأنثى / المرأة إلى الأنثى / الوطن، الأنثى /
مصر، ومثلما خاطبها معظم
الشعراء والأدباء المعاصرين بضمير المؤنث: إيزيس
مثلا عند الكثيرين، أو بهية، من
البهاء، عند د. رشاد رشدي مثلا أو نجيب سرور (ياسين
وبهية) وأحمد فؤاد نجم (مصر
يامه يا بهية / يا ام طرحة وجلابية) أو زهرة، الوردة
الجميلة، عند نجيب محفوظ (في
ميرامار) أو فؤادة ـ من الفؤاد ـ عند ثروت أباظة في
"شيء من الخوف" وغيرهم، نجدها
أيضا تتخذ صفة المؤنث عند الجوهري، ولكن بدون تعيين
اسم لها.
وإذا كان معظم الأدباء والشعراء السابقين كانوا ينطلقون من
موقف الخوف على، أو
الدفاع عن أو الإعجاب بـ: بهية أو زهرة أو إيزيس، أو
فؤادة، فإن الجوهري ينطلق من
موقف الخوف من، أو العتاب لهذا الضمير الأنثوي أو
الرمز الذي لم يعين اسمه.
يقول في مطلع قصيدة "لا عليك":
لا المساء الذي أتعبته المفازاتُ
غنَّى
ولا النورس المستجيرُ ..
يحط على راحتيكِ
لا عليكِ
إنني لا أخاف الوقوفَ على سور حاميتي
وأخاف من العسس ..
المتربصِ في ناظريكِ
لا عليكِ
وينهي القصيدة بقوله:
والصحو يهمي ذبيحا على قدميكِ
لا عليكِ
لا عليكِ سوى
أن تمدَّي لنا .. مرة .. ساعديكِ
في هذين المقطعين من القصيدة، دلائل الخوف من نظرة العين
والمراقبة المخابراتية،
إن صح التعبير، وكأن الشاعر في جملة شعرية قصيرة
ينقلنا إلى عالم رواية "1984"
لجورج أورويل، وبعد أن كانت العين واحة الاطمئنان
والأمان، ومبعث العطف والدفء
والحنان، أصبحت العين مخبرا وعميلا غير سري ورقيبا
على أبناء الوطن المخلصين الذين
لا يأبهون ولا يخافون من الوقوف على خط النار أو خط
الحدود حفاظا على الوطن من
هجمات الأعداء (لا أخاف الوقوفَ على سور حاميتي)
وعلى الرغم من ذلك يخاطب الحبيبة
الأم / الأنثى / الوطن، ويقول لها: لا عليكِ.
وفي نهاية القصيدة تتحول بنية الخوف من هذه الأم الحبيبة
إلى بنية عتاب أو رجاء
أو أمنية أو توسل:
لا عليكِ سوى
أن تمدي لنا .. مرة .. ساعديكِ
ولنتوقف عند (مرة)، التي تحمل شحنة من التوسل من هذا الابن إلى أمه المنصرفة
عنه، والتي يود أن يلقاها أو تساعده ولو مرة واحدة،
بعد أن تركته في مهب رياح
الأفاعي والمستعمرين الجدد والعولمة التي يشير إليها
الشاعر غير مرة في قصائد أخرى
بالديوان (هذي عيري / أتعبها نفس غبار الحزن / ونفس
صليل العولمة) على سبيل المثال.
هذا الرجاء وهذا التوسل المفتوح، به بصيص من أمل، فعلى
الرغم من كل ما حدث،
ويحدث، وتقع آثاره على الشاعر / الضمير الحي اليقظ
لجموع المخلصين لهذا الوطن، فإن
هناك بصيص أمل، أن يُجاب طلبه / طلبنا، أو توسله /
توسلنا، أو رجاؤه / رجاؤنا،
فتمتد يد المساعدة للنهوض من كبواتنا.
لا عليك سوى
أن تمدي لنا .. مرة .. ساعديكِ
مرة واحدة، أو فرصة واحدة، لتري كيف يهب أبناؤك للزود عنك،
وانتشالك من براثن
المستعمرين الجدد، ومن سلبيات عصر العولمة، فهل
تمنحيننا هذه المرة الواحدة، أو تلك
الفرصة؟.
ولعل سائلا أو قارئا متفاعلا مع قصائد الجوهري يسأل: ما
الحال لو لم يُمنح أو
يعطَ الشاعر تلك المرة، أو الفرصة؟ هل يبقى الحال
على ما هو عليه، وعلى المتضرر
اللجوء إلى .. (إلى ماذا؟).
إجابات مفتوحة، مثل نهايات الروايات المفتوحة، وعلى كل قارئ أن يضع النهاية أو
الإجابة التي يريدها أو يراها. وتلك هي متعة الفن
الجيد، أو الشعر الجيد الذي يثير
الفكر والتأمل، ويخلق نوعا من التفاعل مع النص، مع
عدم الإخلال بالشروط الفنية
الأخرى، فالشعر ليس مجرد فكرة تأتي أو ترد على خاطر
الشاعر، فيدونها دون مراعاة
شروط الشعر الأخرى.
من هنا يأتي حرص الجوهري على اختيار عنوان قصيدة "لا عليكِ"
ليطلقه على ديوانه
الجديد، على الرغم من عدم شاعريته في الوهلة الأولى.
وعلى هذا تحمل هذه القصيدة أغلب ملامح الديوان، والتي منها:
الحرص على موسيقى
الشعر من خلال استخدام تفعيلات الخليل دون الدخول في
مغامرات موسيقية أو إيقاعية
أخرى، والحرص على استخدام التقفية بشكل متواتر يسهم
في إبراز العناصر أو القيم
الموسيقية، والحرص على سلامة اللغة العربية مع
تطعيمها بألفاظ أو عبارات مستحدثة من
أمثال: العولمة، الحداثة، الأسلاك الشائكة، حظر
التجوال، الأباتشي، المارينز،
مانفستو، وغيرها. إلى جانب استخدام قاموس صوفي ولغوي
(عن اللغة نفسها)، ينجح الشاعر
في تضفيره مع قاموس المفردات الرومانسية والعصرية
السابق الإشارة إليها.
سنجد من مفردات هذا القاموس الصوفي واللغوي على سبيل
المثال: فضاءات الروح، ماذا
في الجبة؟ التي تنقلنا إلى قول الحلاج أو بشر الحافي
(ما في الجبة غير الله)
وغيرها، سنجد إلى جانب ذلك أيضا: سيبويه والنحاة
(سيبويه .. أغثنا / قد فرَّ حدس
النحاة).
كل هذا يمنح قصائد الديوان حيوية وحركة زمنية ممتدة في
اللغة والتاريخ، فضلا عن
تفاعله مع قضايا الواقع العربي والإسلامي، وخاصة في
فلسطين والعراق، وأبرز مثال على
ذلك قصيدته "بكائية أخيرة لأعرابي" التي يتساءل فيها:
من سرق قميص الفجر
المنشورَ على حبل عروبتنا؟
هكذا تتسع الرؤية من الوطن الصغير (مصر)، إلى الوطن الأكبر
(العالم العربي) وهو
عندما يتساءل عن السارق، فليس لأنه لا يعرف الإجابة،
ليس سؤاله سؤالا للاستفهام، أو
حتى الاستنكار، وإنما سؤال يقصد به إثارة غضب
القارئ، وقد يحوله إلى طاقة فعل
لاستعادة قميص الفجر المسروق، خاصة بعد أن تساءل
قبلها: مَن عَقَرَ جوادي؟ إنه يعرف
الفاعل، يعرف من عقر جواده / جوادنا العربي الأصيل
حتى لا يصهل ولا يحمحم في وجه
الأعداء والمستعمرين الجدد، وحتى لا يستطيع الفارس
العربي اعتلاءه والتوجه به إلى
ميدان المعركة، وحتى يُبطَل عمل الآية الكريمة
"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم."
كيف نعد رباط الخيل، والخيل معقورة، أو مربوطة بإحكام وقوة،
ولا تقدر على
الحركة.
وبدهي أن الجواد هنا رمز لكل أسلحة الميدان التي من الممكن إعدادها. إنها
أسلحة،
في حالتنا هذه، وفي قصيدتنا تلك، معقورة، أو مخزونة لا
تغادر مخازنها الجديدة إلا
إلى مخازن الكهنة، على الرغم من ملايين الدولارات أو
المليارات المدفوعة فيها. ولكن
أن تخرج للمواجهة أو الدفاع أو الاستخدام الفعلي،
فهو أمر بعيد المنال.
لذا كان من الطبيعي أن يُسرق قميص الفجر المنشور على حبل
عروبتنا، فلا يوجد من
يحميه، ولا يوجد السلاح الذي يدافع عنه، فالأسلحة
كما رأينا في مخازنها، خاصة بعد
أن قتل الحادي.
والحادي لفظ يتواءم مع الجواد، كلاهما من بيئة لغوية واحدة، وكلاهما رمز شفيف
لما وراءه من دلالات ومعان. أيضا السؤال عمن قتل
الحادي، يأتي في مرتبة السؤال عمن
عقر جوادي؟
والجميل في هذه القصيدة هو تلك القفزة المفاجئة في قاموسها وألفاظها التراثية
الصحراوية مثل: القوافل والكوخ والمعلقات والأوتاد
ومرفأ الأجداد والأرض القحطانية،
لنرى أمامنا المارينز والأباتشي وما يرمزان إليه من
قوة وغطرسة واستعلاء واستعمار
جديد وآلات الحروب الجديدة.
يقول الشاعر في تلك النقلة أو القفزة في عالم القصيدة:
امنع عني المارينز
الأباتشي
لا تجعل قافيتي سوطا للجلادِ
وتذكَّرْ
أني كنت أقاتل من أجلك
في نفس الأصفادِ!!
إنه يخاطب طير الوادي، ويقول له في بداية القصيدة:
اسمع يا طير الوادي
أول آت من رحم العتق
سنحتكم إليه
من عقر جوادي؟
وكأنه يذكرنا بتلك الواقعة القريشية، حين اتفق سادة قريش في تحكيم أول داخل
عليهم في الكعبة الشريفة، بشأن رفع الحجر الأسود أو
الأسعد لوضعه في مكانه من
الكعبة، فكان أول الداخلين النبي الأمين محمد صلى
الله عليه وسلم.
هذا التوظيف التاريخي لأحداث معاصرة يمنح قصيدة عبد الناصر
الجوهري بُعدا فنيا
مهما، ويكسبها أصالة تراثية منتقاة، فليس كل ما في
التراث يصلح استخدامه، وفي الوقت
نفسه فإن ما يصلح استخدامه يجب توظيفه أو استخدامه
بذكاء فني واقتدار لغوي ليتفاعل
معه القارئ. وهذا ما التفت إليه شاعر مثل أمل دنقل
الذي يعد من أكثر الشعراء
المعاصرين توظيفا ذكيا وناجحا للتراث العربي، ونذكر
من أعماله أو قصائده في هذا
الخصوص: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ولا تصالح،
ومراثي اليمامة وغيرها.
ولكن ما المقصود بطير الوادي الذي يوجه إليه الشاعر دفة
حديثه في أول القصيدة،
ثم في وسطها تقريبا في قوله:
اسمع يا طير الوادي
هب أنك لا تعلم قاموس النجدة
أو حتى لا تدري سر الإبحار
إلى الأمجادِ
قد نتوقف قليلا عن دلالة هذا الطير، ونتساءل هل المقصود به
الحرية؟ ولنختبر هذا
الفرض.
إن الطائر هنا ليس مكبلا في قفص من حديد، ولكنه يعيش في
الوادي بكل رحابته
واتساعه، ومن ثم يملك القدرة على التحليق والطيران
هنا وهناك، وهو يأتي على عكس
الصورة التي قدمها لنا الشاعر عن النوارس والعنادل
في قوله:
ها أعشاشي المسلوبة ..
تهجرها أسراب الصحو ..
قبيل محاصرة .. نوارس (قدسي)
وعنادل (بغدادي)
اسمع يا طير الوادي
إذن هذا الطير غير محاصر وغير مكبل، ومن ثم يصلح لأن نختاره
رمزا للحرية التي
يشكو إليها الشاعر، فالكل يتحدث باسم الحرية،
واحتلال العراق جاء باسم الحرية ونشر
الديموقراطية، فلم يجد الشاعر بدا من الشكوى إلى هذه
الحرية، ورفع الأمرِ لها بل
سؤالها مَنْ عقر جواده الذي سيدافع به عن قومه؟ ومن
يمنع عنه المارينز والأباتشي
التي تستخدم باسم تلك الحرية في الهجوم والعدوان
والاحتلال والقتل والتشريد
والتدمير والإبادة إلى آخر هذا القاموس؟.
تلك كانت وقفة مع، أو إطلالة على، بعض قصائد ديوان "لا
عليكِ" للشاعر الشاب عبد
الناصر الجوهري الذي صدر مؤخرا عن سلسلة "أدب
الجماهير" التي تصدر في المنصورة،
ويشرف عليها الكاتب الكبير فؤاد حجازي، اتضح من
خلالها أهم خصائص الشعر لديه،
واتجاهاته وملامحه، وهو يعد، من وجهة نظري، مكسبا
جديدا للحركة الشعرية العربية
المعاصرة.
Comments 发表评论
Commentaires تعليقات |
|
|
|
 |
 |
|
|
