|
 الناقد
الحق ... والآخرون ! الناقد
الحق ... والآخرون !
أحمد عبد المعطي حجازي - مصر
إذا كان النقد الأدبي قراءة ذكية للنصوص الأدبية, فكل قارئ
ذكي يستطيع أن يكون ناقدا, فإذا كانت معرفة الأدب أول شرط في
هذه القراءة, فالذين يدرسون الأدب ويشتغلون بتدريسه أقرب من
غيرهم للاشتغال بالنقد, علي أن يكون الفرق واضحا لهم ولغيرهم
بين تدريس الأدب ونقده.. فنقد الأدب شيء وتدريسه شيء آخر.
تدريس الأدب عمل يقصد به تزويد الطالب بمعرفة أدبية يشترط فيها
أن تكون واضحة ومفهومة لدي أكبر عدد من الطلاب الذين يعرف
المدرس مستواهم, فيبدأ معهم مما يعرفونه ليصل بهم إلي ما يجب
أن يعرفوه, دون أن يحملهم ما لا يطيقون.. وهو لهذا حريص
علي أن يقدم لهم المعلومات الأساسية التي لابد من معرفتها لفهم
النص والربط بينه وبين النصوص الأخري, وبينها وبين ما كان في
العصر الذي قيلت فيه من فنون وأفكار, وكلما قطع مع طلابه
مرحلة انتقل إلي المرحلة التي تليها.. وهو بهذا ينتقل بهم من
المعلوم للمجهول, ومن الحفظ إلي التمثيل, ومن التذكر إلي
التخيل, ومما يتلقونه عنه إلي ما يجتهدون هم في تحصيله,
ومما يعرفونه جماعة إلي ما يعرفه كل منهم علي حدة.
هكذا تكون الميزة الأساسية المطلوبة فيمن يشتغل بالتدريس هي
قدرته علي أن يتعهد طلابه الذين يعرفهم فردا فردا, ويرعاهم
يوما بعد يوم وسنة بعد أخري. الميزة الأساسية في مدرس الأدب
لا تتمثل في سعة علمه بقدر ما تتمثل في قدرته علي نقل علمه
لطلابه علي النحو الذي يحببهم فيه ويغريهم بتمثله والاستزادة
منه والانفعال به حتي يصبح لبنة في الكيان وعنصرا من عناصر
الشخصية.. وهكذا يكون المدرس مربيا.
أما نقد الأدب فعمل آخر, لأنه يتطلب إلي جانب العلم هذا
الاستعداد أو هذه الملكة التي نراها واضحة فيمن جمعوا بين قول
الشعر ونقده كالمعري, وإيليوت, والعقاد. وإذا كان المدرس
يضع أيدي طلابه علي الحقائق المعلومة المتفق علي صحتها,
فالناقد مسموح له بل مطلوب منه أن يظن وأن يتحدث عن الغامض
والمجهول الذي لا يفصح عنه ظاهر العبارة, وإنما يلمع مما
وراءها, وربما قالت العبارة شيئا ففهم الناقد شيئا آخر,
لأن الناقد ليس مجرد متلق لما يقال وإنما هو قائل آخر أو شريك
في القول لأنه قادر علي أن يقلب العبارة علي وجوهها
المختلفة, وأن يفهم منها ما لا يظهر لغيره, وربما رأي فيها
ما لم يره كاتبها نفسه.
وكل ما يطلب منه في هذه الحالة أن يفسر قراءته ويبررها بقدر ما
يستطيع النقد أن يفسر ويبرر, فربما كان الأثر بعيدا غامضا,
وربما كان الانفعال استغراقا كاملا تعجز لغة النقد عن الإحاطة
به مهما كانت ذكية عالمة.
وهذا ما اعترف به النقاد الغربيون الذين حاولوا في هذا العصر
أن يجعلوا النقد علما موضوعيا يعتمد علي التحليلات والإحصائيات
اللغوية, ثم عادوا ليعترفوا بعدم كفاية هذه الطريقة, وكان
الناقد العربي القديم الآمدي قد وضع يده قبل الجميع علي هذه
الحقيقة فقال في الموازنة إنه سيعلل أحكامه بقدر ما يستطيع,
لكنه نبهنا إلي أن الناقد ربما خطر له في النص ما لم يمكن
إخراجه إلي التبيان ولا إظهاره إلي الاحتجاج, وهي علة ما لا
يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة, وبهذا يفضل
أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت قريحته توقلت
دربته.
وهو يحكي عن
اسحق الموصلي أن المعتصم سأله يوما: أخبرني عن معرفة النغم
وبينها فأجاب إسحق: إن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة
ولا تؤديها الصفة.
ويعلق الدكتور مندور الذي نبهنا إلي هذا النص علي كلام اسحق
الموصلي بقوله وفي الأدب أشياء كثيرة شأنها شأن النغم يحيط بها
الذوق ولا تؤديها الصفة.
هكذا نري أن حيرة الناقد أمام النص الرائع تزداد كلما كان علمه
أوسع وذوقه أرهف... لأنه ينظر في النص فيري ما لا يري
غيره, ويسمع ما لا يسمعه سواه, ومن هنا لا يسعفه الوصف,
لأن اللغة لا تصف إلا ما تراه, فإذا اتسعت الرؤية ضاقت
العبارة, كما يقول النفري.
لكن يبدو أن الذي أدركه الآمدي في القرن العاشر الميلادي,
والموصلي في القرن التاسع, لايزال مجهولا عندنا.. والنتيجة
ما نراه من هذا الخلط الذي استشري وامتدت عدواه إلي كل شيء فلم
نعد نعرف أين ينتهي النثر ويبدأ الشعر؟.. وما هو الفرق بين
الشاعر والزجال؟.. وكيف نميز بين المدرسين والنقاد؟
ومن المؤكد أن بين الشعر والنثر صلة.. وأن الزجال قد يكون
شاعرا كما يمكن أن يكون الشاعر زجالا, وأن مدرس الأدب أقرب
من غيره لنقد الأدب, لكن الفروق لابد أن تظل واضحة معلومة
بين هذه الأنواع وهذه الوظائف, حتي يكون هناك مبرر لأن نطلق
علي الشعر اسمه الذي يختلف عن الاسم الذي نطلقه علي النثر,
وأن نميز بين ما نطلبه من المدرس وما نطلبه من الناقد.
عندما كان طه حسين يجلس علي عرش النقد العربي ويمسك صولجانه,
كان يدرس الأدب في الجامعة, لكنه لم يكن ناقدا بحكم أنه
أستاذ, وإنما بدأ حياته شاعرا وناقدا قبل أن يذهب إلي
باريس, وقبل أن يعود بالدكتوراه, وقبل أن يعين مدرسا في
الجامعة.
وفي ذلك
الوقت, كان من أساتذة الجامعة أمثال الدكتور أحمد ضيف,
والدكتور أحمد أمين, والأستاذ أمين الخولي, الذين لايشك
أحد في علمهم أو في ذوقهم, لكنهم لم يشتغلوا بالنقد كما فعل
طه حسين... صحيح أن بعضهم حاضر في النقد والبلاغة, وله في
النقد النظري مؤلفات رصينة منها كتاب أحمد أمين النقد الأدبي
الذي يتحدث فيه عن أصول النقد ومبادئه وتاريخه عند الأوروبيين
والعرب, لكن النقد النظري شيء والنقد التطبيقي الذي مارسه طه
حسين شيء آخر... النقد النظري يناقش المفاهيم والنظريات
ويحدد الأشكال والتيارات والمذاهب, أما النقد التطبيقي
فيرينا كيف تحولت هذه المفاهيم وهذه الأشكال والمذاهب إلي
إبداع حي وجمال لا ينفد.
والناقد الحق هو العالم الموهوب المتذوق الذي يتمثل النظرية
ويطبقها بتصرف وحرية فيحاور النص ويناوره ويداوره, ويداعبه
ويلاعبه, ويتغلغل في أعماقه ويكشف عن أسراره ومفاتنه.
وهناك نقاد يكتفون بحفظ النظرية, وربما حفظوا نصفها وضاع
منهم نصفها الآخر!
|
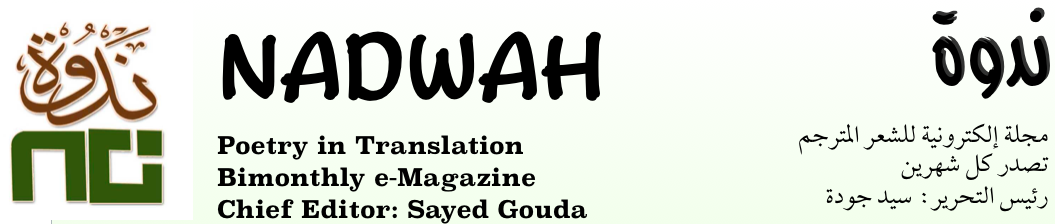 ف
ف

