لقد تَخِذتِ اللسانيات الجملة موضوعا لتحقيقها و معالجتها.
و في إطار مُُتناهٍ ،كما لدى دي سوسير، توقفت المعرفة
اللسانياتية الممكنة نفسها عند الكلمة أو السانتاغم/
التركيب. و رامت البلاغة الكلاسية تشفير قواعد بناء
الخطاب، بيد أن قصدها و غايتها النموذجية - رغم إهمالها
الأشكالَ اللفظية المادية- قائمة ،إلى حد بعيد، على أساس
احتواء إرْثها بعضاً من أضْرُب التعليم القابلة للاستعمال.
و أخيراً، فإن الأسلوبية ،في منظور بالّي، اهتمت غالبا
بالتداخُل بين الملفوظ (Enoncé) و التلفـُّظ
(Enonciation)، و بتنظيم الملفوظ نفسِه. و تم الخُلوص إلى
وجود فراغ في نظرية النص، رغم أنه كانت ثمة ملاحظات
مبعْثرة آتية من جانب آداب لم تتراكمْ بعدُ بما فيه
الكفاية.
إن مفهوم النص غير متموْضع في الإطار الذي تتموضع فيه
الجملة (أو العبارة أو التركيب إلخ). و بهذا المعنى، لزم
أن يختلف النص عن الفِقْرة باعتبارها وحدة طيبوغرافية
مشكّلة من عدة جملٍ. إن النص قد يكون جملة، كما قد يكون
كتابا بأكْمله. إنه يُحدَّد اعتمادا على استقلاليته بذاته
و على حدّه (و بمعنى آخر، فبعض النصوص غير "مفتوح"). يكوّن
النص نظاما/ نسَقا لا يتطابق إطلاقاً مع النسق اللسانياتي،
و لكن يدخل في علاقةٍ معه؛ علاقةِ جوار طورا، و علاقة
تماثل طورا آخر. و باصطلاحات الكلوسيماتيكي الدنماركي
ل.هلمسليف، فالنصُّ نظام إيحائي (Système connotatif)،
لأنه ثانٍ بالنظر إلى نظام دلالي آخر. و إذا وقع التمييز
داخل الجملة اللغوية بين مكوناتها الفونولوجية و التركيبية
و الدلالية، فإنه من الممكن أن يتم تمييزها كذلك على مستوى
النص بغضّ الطرف عمّا إذا كانت هذه المكوناتُ موجودة في
الإطار نفسه. و هكذا، فبخصوص النص سنتحدث عن الجانب اللفظي
(Aspect verbal) الذي سيتألف من جميع العناصر اللسانياتية
المحض (الفونولوجية و النحوية إلخ ( للجمل التي تكوّنه، و
عن الجانب التركيبي حيث يُحال على العلاقات بين وحدات نصية
سواء أكانت جملا أم مجموعات جُمْلِية أم نحوها لا على
تركيب الجمل، و عن الجانب الدلالي ،أخيرا، المنتَج المعقد
لمحتوى الوحدات اللسانياتية الدلالي. و لكلٍّ من هذه
الجوانب الثلاثة إشكاليته الخاصة به، و يؤسس أحد أهم أصناف
التحليل النصي؛ و يتعلق الأمر بالتحليلات البلاغية و
السردية و الثيماتية (أو الموضوعاتية).
ينبغي ،إذاً، أن تسَجّل جيداً بأن الدراسة الشاملة للنص
المواجَه لا تتلخص في اللسانيات التوزيعية التي راجت طَوال
خمسينيات القرن العشرين كما ادّعى بعضُهم، و هي المسمّاة
"تحليل الخطاب" (Analyse du discours) كما عند زيليغ
هاريسّ و تلاميذه، بحيث يتأسس منهجُه على تقطيع النص إلى
عناصرَ(عادة، من بعد أحد المركبات أو عدد منها) تتجمع في
أقسام التعادل (Classes d’équivalence). بحيث إن قسما منها
يتألف من العناصر التي يمكن أن تتراءى في سياق مطابِق أو
مماثِل، و لا يقع الانشغال مسبَّقا بمعرفة ما إذا كانت هذه
العناصر المتعادلة و المتساوية ذات معنى واحد أو لا. إن
بعض الجمل الحمّالة لعناصر متعادلة و أخرى غير متعادلة
تُـوصَف دوما كما لو أن بينها علاقات التحويل (هذا المفهوم
مؤتىً به للتفريق بين التحويلات التوليدية و التحويلات
الخطابية). و الملحوظ أن أبحاثا موازية قد أنجزت حول عناصر
الجملة التي تحوي مرجعية على الجملة السابقة...إلخ.
إن الجانبين الدلالي و اللفظي لنص مّا يثيران مشكلات يجب
أن تدْرَس ضمن سياقها الخاص. و نشير هنا تحديدا إلى أن أحد
التحليلات النادرة التي تمسّ الجانب الدلالي للنص تتموقع
ضمن منظور التاغْميميك (Tagmémique)، و نقصد دراسة بيكر
(A.L.Becker) التي حلل فيها خطابات من النمط "المعروض"
(Exposé)، و استشفَّ منها خطاطتين أساسيتين:
* إحداهما: موضوعة- تحديد- رسْم.
* و الأخرى: مشكلة- حلّ.
و كلتاهما قد تتغير بمساعدة عمليات يمكن أن تتكرر أو
تتعاقب؛ من مثل الإلغاء، و الاستبدال، و الإضافة، و
التوْليف... و سندرس فيما يأتي ،خصيصاً، جانب النص
التركيبي.
و قبل الشروع في هذه الدراسة التحليلية، نسجل أيضا أنه مذ
سنواتٍ في فرنسا حاولت الأبحاث ذات المنحى السيميوطيقي
(ككريستيفا مثلا؛ صاحبة كتاب"Semeiotiké"/ باريس/ 1969)
تأسيس نظرية عامة للنص أين سيتلقى هذا المفهوم معنى خاصا
جدا، و لا يمكن أن ينطبق على أي متوالية منظّمة من الجمل.
و تستند دراسة النص من جانبه التركيبي على التحليل
الافتراضي (Analyse propositionnelle) الذي من خلاله نلخص
الخطاب و نجزئه إلى قضايا منطقية مبسّطة، قائمة على أساس
عامل (ذات) و محمول، أو عدة عوامل (مثل الذات و الموضوع) و
محمول، و ذلك بحسب النموذج الافتراضي المُعطى. و يقتضي
حضور محموليْن، و اللذيْن قد يكونان صفتين أو فعلين، حضورَ
قضيتيْن. و هكذا، فجملة "الطفل يبكي" ليست سوى شكلٍ
لسانياتي، مزيج - من وجهة نظر منطقية- من قضيتين متتاليتين
هما: "إكس طفل"، و "إكس يبكي". إن القضية (Proposition)
تتناسب و ما أسْماه جون ديبوا(J.Dubois ) "الجملة الدنيا"
(Phrase minimale). و انطلاقا مما سلف، يمكن أن ندرس
العلاقات الموجودة بين القضايا.
إن هذا الأمرَ يمكن أن يتم بثلاثة أشكال تعكس ثلاثة
تنظيمات نصية (غالبا ما تقدَّم من داخل نص بعينه). أولُـها
التنظيم المنطقي الذي يجمع كل العلاقات المنطقية بين
القضايا؛ نحو: السّبَبية، و الفصل، و الوصل، و النفي ، و
التضمُّن. فالسببية تتردد ،بخاصة، في الحكايات، و هي - من
ناحية أخرى- ليست بمفهوم بسيطٍ، إنها تضم ظروف الوجود، و
النتائج، و الموتيفات/الحوافز...إلخ. و العلاقات من قَبيل
التضمن تتواتر، تحديداً، في الخطاب الديداكتيكي (القاعدة-
المثال).
و ثانيها التنظيم الزمني الذي ينبني على تعاقب أحداثٍ
يستدعيها الخطاب. و لا يكون إذاً إلا في حالة خطاب مرجعي
(تمْثيلي) يأخذ في الاعتبار البُعد الزمني، كما هو الشأن
في القصة أو الحكاية. و عليه، فهو يَغيب في الخطاب غير
التمثيلي؛ مثل الشعر الغنائي، و في الخطاب الوصفي أيضا؛
مثل الدراسة السوسيولوجية التزامُنية. و ثمة أنواعٌ نصية
يهيمن فيها التنظيم الزمني؛ كالخبر الحميم، و السيرة سواء
الذاتية أم الغيْرية.
و ثالثها ،و هو الأخير، التنظيم الحَيْزي، و نتحدث عنه حين
لا تكون العلاقة بين القضايا منطقية و لا زمنية، و لكن
تشاكُلا أو تبايُناً... و مثاله الإيقاع الشعريُّ.
المصدر:
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,
O.Ducrot et T.Todorov, Coll. Points, Editions du Seuil,
Paris,1972, P375-378.
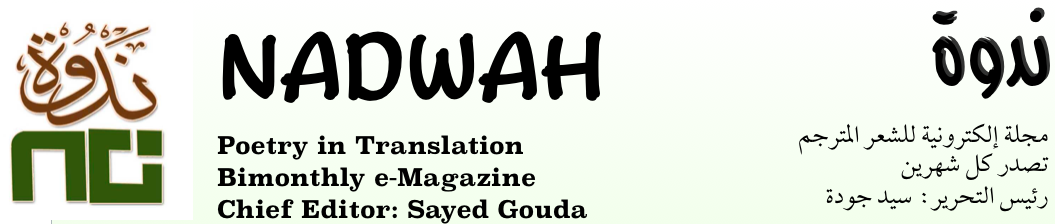 ف
ف
