كل إنسان يتبع دينه لا يشاركه في ذلك أحد!في ذكري
حافظ وشوقي نتذكر انفسنا, ونراجع تاريخنا الحديث كله, بما تحقق فيه ومالم
يتحقق, ماكسبناه فيه وما خسرناه. فحافظ وشوقي وجهان مشرقان من وجوه هذا
التاريخ الذي نهضنا فيه من نوم طويل, واستعدنا وعينا بأنفسنا وبالعالم بما
نحن فيه وما ينبغي ان نصير اليه.
حافظ وشوقي ليسا مجرد شاعرين نقرأ لهما كما نقرأ لشاعر لايربطنا به إلا
الشعر, ولم يقتصر همهما علي نظم قصائد جيدة يضيف بها كل منهما اسمه الي قائمة
الشعراء المجيدين, وإنما وحد كل منهما بين صوته وصوت بلاده التي سكتت طويلا
أو أرغمت علي السكوت.
والشاعر المجيد في كل الأحوال لابد ان يتجاوز نفسه, وأن يتوحد بغيره, والا
فشعره يخصه ولايهم سواه, فاذا اضاف الي وعيه بشروط الجودة الفنية وعيه بمطالب
عصره وشروط وجوده اصبح شاعر النيل, كما استحق حافظ ان يلقب, وامير الشعراء
كما استحق شوقي أن يكون. من هنا تحل ذكري الشاعرين فنتذكرهما ونتذكر من
سبقوهما من آباء النهضة ومن لحقوهما من ابنائها.
ولقد رأينا أن الذين ينكرون شاعرية حافظ وشوقي
لايقفون عند هذا الحد, بل ينكرون معهما البارودي وغير البارودي ممن سبقوا
ولحقوا, ثم يشتطون اكثر فينكرون النهضة المصرية كلها, كتابها وشعراءها من
الطهطاوي الي الأفغاني ومحمد عبده, ومن البارودي الي أحمد زكي ابو شادي
وابراهيم ناجي, ثم يطلقون لانفسهم العنان فينكرون النهضة العربية كلها,
لأنها كانت في رأيهم استعادة للقديم وتكرارا له.
وسوف نري أن هذه الاحكام ليست إلا اقوالا
مرسلة لاتقوم علي اساس ولاتثبت لمناقشة جادة. اولا لأن النهضة اوسع واغني من
أن تختصر في عمل او بضعة اعمال لمؤلف او بضعة مؤلفين. والذي يريد ان يتحدث عن
النهضة المصرية محتاج لأن يلم بما كتبه الذين ظهروا فيها وهم عشرات بل مئات من
الشعراء والعلماء والكتاب والمفكرين والفنانين الذين يتفقون في جانب ويختلفون
في جوانب.
ثم ان الحديث عن النهضة لايستقيم إذا اكتفينا بقراءة ماكتبه هؤلاء, وإنما
ينبغي ان نضع كلا منهم في مكانه من تاريخ بلاده ومما حققه المصريون عامة خلال
القرنين الأخيرين في كل المجالات.
وفي اعتقادي أن قارئا جادا لهذا التاريخ بكل ماتحقق فيه لايمكن أن يخرج بهذه
الأحكام التي قد تكون تعبيرا عن أمزجة حادة أو ردود أفعال عصبية للتطورات
السياسية العنيفة التي شهدتها مصر والمنطقة العربية عامة في النصف الأخير من
القرن الماضي. وسوف نختبر معا هذه الأحكام, ونعرضها علي مابين أيدينا من
النصوص والوقائع الثابتة لنميز منها بين الصحيح والفاسد.
هل صحيح أن الطهطاوي كان منغلقا علي الصعيد
الديني, وأنه لم يضف شيئا جديدا إلي الموقف التوفيقي الذي وقفه الفلاسفة
العرب القدامي, وأكدوا فيه الوحدة بين الدين والفلسفة كما يقول الشاعر السوري
أدونيس في كتابه صدمة الحداثة!
وقد اعتمد أدونيس في هذا الحكم علي كتابين من كتب الطهطاوي هما تخليص الابريز
في تلخيص باريز ومناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية, فهو يستشهد
بهما ويقول انهما كتاباه الأساسيان. ولاشك أن هذين الكتابين من أهم مؤلفات
الطهطاوي, لكن الطهطاوي له مؤلفات أخري لاتقل أهمية عنهما, ومنها المرشد
الأمين للبنات والبنين الذي صدر في آخر عام1872 قبل وفاة الطهطاوي بشهور
قليلة, فهو من كتبه الأخيرة, التي تعكس فكره بعد اكتمال نضجه كما يقول
الدكتور عماد أبوغازي في تقديمه له. وحسبنا أن نقرأ ماجاء في هذا الكتاب عن
حق المرأة في أن تتعلم وحقها في أن تعمل لأن التعليم يزيد هن أدبا وعقلا كما
أنه يمكن المرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطي من الأشغال مايتعاطاه الرجال.
وهذا من شأنه أن يشغل عن البطالة, فان فراغ أيديهن من العمل يشغل ألسنتهن
بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل. وإذا كانت البطالة مذمومة في
حق الرجال فهي مذمة عظيمة في حق النساء.
وكان الطهطاوي قد تعرض من قبل في تخليص الابريز لمسألة خروج المرأة واحتجابها
وعلاقة ذلك بالعفة فقال إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لايأتي من كشفهن
أو سترهن, بل منشأ ذلك التربية الجيدة والخسيسة, والتعود علي محبة واحد دون
غيره, وعدم التشريك في المحبة, والالتئام بين الزوجين.
هذا الكلام يقوله الطهطاوي وينشره علي الناس
قبل مائة وسبعين سنة حين كانت أسواق الرقيق في القاهرة لاتزال منصوبة عامرة,
وكان للرجل أن يملك ماتستطيع أن تملكه يمينه من الجواري الشركسيات والروميات
والحبشيات!
والطهطاوي لم يكتف بأن يقول, بل قال وفعل فجاء فعله مصدقا قوله. إذ وجد من
العدل ألا يتزوج الرجل الشريف إلا امرأة واحدة فكتب تعهدا حرره بخط يده عند
زواجه من ابنة خاله كريمة الأنصاري أنه يبقي معها وحدها علي الزوجية دون غيرها
من زوجة أخري أو جارية!
كم رجلا مصريا يتاح له الآن ما كان متاحا للطهطاوي لكنه يلتزم نبل الطهطاوي
وعدله؟ بل نحن نري أن وضع المرأة المصرية يتراجع هذه الأيام بعد أن خطت خطوات
واسعة إلي الأمام, وأن الرجل ينظر إليها, وأنها تنظر إلي نفسها كأنها مجرد
جسد مثير, وأن الفنانات يعتزلن الفن, وترتفع الأصوات من جديد تطالب المرأة
بالتزام البيت!
هذا الموقف من المرأة لم يكن إلا تعبيرا عن روح جديدة هي روح النهضة التي
يمثلها الطهطاوي ويعبر عنها في كل ما تعرض له من قضايا السياسة والمجتمع والوطن
والعالم والعلم والدين.
لقد ذهب الطهطاوي إلي باريس إنسانا وعاد إنسانا آخر. ذهب شابا في الخامسة
والعشرين من عمره لم يتح له من العلم إلا ما كان يدرسه المصريون في الأزهر من
علوم اللغة والدين بعد أن أصبحت هذه العلوم نصوصا ميتة معزولة عن الحياة,
وعاد بعد خمس سنوات, وقد أتقن الفرنسية واغترف من ثقافتها الأدبية والعلمية
والفلسفية ما تجاوز به حدود طالب العلم ليصبح رائد نهضة ومبشرا بعصر جديد.
والذين يقرأون الطهطاوي ليجدوا فيما يقول
شواهد يؤيدون بها آراءهم السلبية المسبقة فيه وفيما يمثله لا يقنعوننا ولا
يخدعون إلا أنفسهم. والطهطاوي لا يعرف بعبارات مقتطفة من كتاب له أو
كتابين, وإنما يعرف بمسيرته كلها, وهي مسيرة حافلة بالتحولات العميقة
والانقلابات المزلزلة. وحسبك أن تفكر فيما تعرض له هذا الشيخ الشاب وهو يقرأ
فولتير اللاأدري, ويتتبع مع مونتسيكو نظم الحكم المختلفة, ويتأمل ما شرحه
روسو في كتابه العقد الاجتماعي.
انقلاب حقيقي بدأه الطهطاوي بالدروس المنتظمة التي كان يتلقاها في اللغة
الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والحساب والهندسة, حتي أصبح قادرا علي أن يقرأ
في السياسة والعلم والفلسفة, ثم يرجع إلي بلاده ليعيد تثقيفها كما أعاد تثقيف
نفسه, ويرفعها فوق كاهله يعبر بها القرون حتي يضعها في العصور الحديثة.
ولقد بدأ فذكر المصريين بأنهم أمة لها تاريخها
العريق وحضارتها الباذخة, وحقها في أن تتحرر وتتقدم وتستعيد ما كان لها في
ماضيها المجيد. ولا يخفي علي ضمائر أولي البصائر وخواطر أهل الفضل الباهر أن
مصر نازعت قدماء الأمم في الأقدمية, فسلموا لها أنهم دونها في مرتبة
الأهمية, وإن لم تسبقها آية في سبيل التمدنية, ولا في حومة تقنين القوانين
وتشريع الأحكام المدنية... وهو لا يكتفي بأن يتحدث عن مصر كمؤرخ كما فعل في
كتابه أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسماعيل, وإنما يتحدث عنها
أيضا كشاعر مشبوب العاطفة!
لمصرنا سالف
المزية
قد مدنت سائر البرية
منها أثينا غدت ملية
بحكمة قصرها مشيد
هذه التذكرة كانت نقلة جوهرية في الوعي المصري الحديث. إذ كان المصريون قد
نسوا بعد عشرين قرنا أو أكثر من استعباد الأجانب لهم واحتلالهم بلادهم أنهم
أمة. وربما جعلتهم عواطفهم الدينية يرضون بإلحاق أنفسهم بالغزاة الذين
يشاركونهم انتماءهم الديني, حين كان الانتماء الديني مقدما علي الانتماء
الوطني.
فإذا
كان المصريون مصريين لأنهم يعيشون حياة مشتركة في وطن واحد, وليس لأنهم أو
لأن معظمهم يدينون بدين واحد فمعني هذا أن روابطهم ومصالحهم الدنيوية هي التي
تجمع بينهم, أو قل إنها حقوقهم الطبيعية التي يتمتعون بها لأنهم بشر ولأنهم
مواطنون فأخوة الوطن لها حقوق كما يقول الطهطاوي في مناهج الألباب, فمن حق
المصريين إذن أن يكونوا أحرارا, وأن يعملوا ويجنوا ثمار عملهم, وأن ينعموا
بالأمن, وأن يثوروا علي من يستبد بهم وينفرد دونهم بالسلطة ويعتدي علي أي حق
من هذه الحقوق.
صحيح أن الطهطاوي لم يصرح بحق المصريين في الديمقراطية وفي مقاومة الطغاة لأن
الوعي الوطني كان في بدايته, ولأن الشروط التي كان يعمل في اطارها كانت تفرض
عليه في هذه المسألة أن يلجأ للتلميح, وإن بلغ التلميح أحيانا كثيرة حد
التصريح. هكذا اجتهد في وضع المباديء والمقدمات, وألح في التعبير عنها,
وشرحها باستفاضة, واثقا بأنها ستصل بنا لا محالة إلي نتائجها المنطقية, لأن
الوطني ـ يقصد المواطن ـ يتمتع بحقوق بلده. وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة
في الجمعية التأنسية, ولأن حقوق الإنسان واحدة, وما يصح في فرنسا يصح في
مصر, وما يستحسنه العقل هناك يستحسنه العقل هنا ويستحسنه الدين أيضا.
والعدل ـ كما يقول ـ أساس العمران.
والطهطاوي يترجم الميثاق الدستوري الفرنسي ويعلق عليه فيحدثنا عن حق المواطن في
أن يختار حكومته, وأن يعتنق الدين الذي يشاء, وأن يفكر بحرية ويعبر عن رأيه
بحرية. كل إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يحب, لايشاركه أحد
في ذلك, بل يعان علي ذلك ويمنع من يتعرض له في عبادته. وهو يعلق علي هذه
المادة, وهي المادة الخامسة في الميثاق قائلا: إنها نافعة لأهل البلاد
والغرباء. أما المادة الثامنة فتنص علي حرية الرأي. وقد ترجمها الطهطاوي
هكذا لايمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه ويطبعه بشرط ألا يضر ما في
هذا القانون. ثم يعلق قائلا إنها تقوي كل إنسان علي أن يظهر رأيه وعلمه وسائر
مايخطر بباله مما لايضر غيره, فيعلم الانسان سائر ما في نفس صاحبه, خصوصا
الورقات اليومية ـ أي الصحف ـ المسماة بالجورنالات والكازيكات.
وجدير بالذكر أن الطهطاوي كان شاهد عيان علي
الثورة التي اشتعلت في باريس وفي فرنسا كلها سنة1830 علي الملك لويس فيليب
حين ضاق ببعض ما كانت تنشره الصحف آنذاك فأصدر أمره بفرض الرقابة عليها دون أن
يرجع للبرلمان أو يتقيد بالنصوص الدستورية التي تضمن حرية التعبير فصنع وحده ـ
كما يقول الطهطاوي ـ مالاينفذ إلا إذا كان صنعه مع غيره أي أن الملك خرج علي
الدستور فأصبح من حق الأمة أن تقاومه وتثور عليه.
هكذا كان الطهطاوي يتحدث عن فرنسا ويوجه خطابه
للمصريين داعيا للديموقراطية مبشرا بالدستور وحقوق الانسان حتي أثمرت في
النهاية جهوده فانعقد سنة1866 مجلس شوري النواب الذي كان له أن يقدم المشورة
لحكومة الخديو اسماعيل دون أن يكون له الحق في مساءلتها, لكنه كان خطوة أولي
في الطريق الطويل الذي قطعه المصريون ولايزالون للوصول الي ديموقراطية
حقيقية.
فاذا
كان الطهطاوي هو أول خيط أبيض يشق ظلمات القرون, وأول صوت واثق يخرج بعد هذا
الصمت المطبق فهو ليس مجرد وجه من وجوه النهضة وإنما هو رائدها.
لقد ظل يكدح خمس سنوات في فرنسا ليلم بشيء مما
حققه الأوروبيون في خمسة قرون. ولقد عاد إلينا يهز لغتنا التي كانت قد ماتت
أو غابت عن الوعي ويحايلها لتقبل الدخول في هذا الحوار المرهق وتوسع صدرها
لأمثال فولتير, ومونتسكيو, وروسو, وفينيلون, ومالت بران, وجومار,
وبور لاماكي, ودوبنج, وفيرار, وليجاندر وسواهم من الفلاسفة,
والمؤرخين, والجغرافيين, والرياضيين, والعسكريين.
والمجال لايتسع لحديث مفصل عن المفاهيم
الجديدة التي أدخلها الطهطاوي في اللغة العربية وعن المصطلحات التي سماها
بها. وهذا وحده إنجاز ضخم خرجت به لغتنا وخرجنا معها من الموت الي الحياة,
وقفزنا من عالم القرون الوسطي إلي هذا العالم الذي نعيش فيه, والفضل
للطهطاوي.
بدون الطهطاوي لم يكن ممكنا أن تظهر هذه الأجيال من المثقفين المصريين الذي
حملوا الأمانة, بعده من أمثال محمد عبده, وحسين المرصفي, ومحمود سامي
البارودي, وعبدالله النديم, وسعد زغلول, وأحمد لطفي السيد. الصحف
الوطنية التي بدأت تظهر في ستينيات القرن التاسع عشر, والأحزاب السياسية التي
بدأت تتشكل والمدارس العليا, ومدارس البنات, والمسارح, ودار الأوبرا.
الطهطاوي الصعيدي الأزهري هو الذي يتحدث باحترام عن فن الرقص كما عرفه في فرنسا
فيقول الرقص عندهم فن من الفنون. وقد أشار إليه المسعودي في تاريخه المسمي
مروج الذهب. فهو نظير المصارعة في موازنة الأعضاء ودفع قوي بعضها إلي بعض
فليس كل قوي يعرف المصارعة, بل قد يغلبه ضعيف البنية بواسطة الحيل المقررة
عندهم. وما كل راقص يقدر علي دقائق حركات الأعضاء. وظهر أن الرقص والمصارعة
مرجعهما شيء يعرف بالتأمل. الرقص إذن تفكير. هل أتيح للسادة الذين زعموا أن
الطهطاوي منغلق من الناحية الدينية أن يقرأوا هذه السطور؟ فبأي حق إذن يتهمونه
بالانغلاق؟
يقولون إنه لم يقطع مابينه وبين ثقافته التقليدية الموروثة, وإن جهوده انصبت
علي التوفيق بين الحضارة الغربية الحديثة والاسلام.
ولاشك أن الطهطاوي ظل وفيا لعقيدته الدينية,
لكن وفاءه لثقافته الجديدة لم يكن أقل كما رأينا.. ومن هنا كان عليه أن يوفق
بين ما ورثه من ماضيه وما تعلمه في فرنسا. وهل كان هناك طريق آخر؟
من المؤكد أن القطيعة التي يدعو لها البعض لم
تخطر للطهطاوي علي بال, أولا لأنها مستحيلة, فكيف يفر المرء من نفسه؟ كيف
يخرج من انتماءاته ووراثاته التي تشكل وعيه بوجوده؟ يراجعها نعم ويعدلها ويضيف
إليها, لكن دون أن يقطع مابينه وبينها وإلا فتلك هي العدمية وهذا هو
الانتحار.
ثم إن هذه القطيعة غير مفيدة بالنسبة للطهطاوي الذي لم يكن مجرد مثقف مشتغل
بالتنظير باحث عن النقاء المذهبي, وإنما كان صاحب مشروع يسعي لتحقيقه في
الواقع, فهل كان بوسع الطهطاوي أن يخاطب المصريين ويقنعهم بما يدعوهم إليه
إذا تركهم يشكون في عقيدته ويسيئون الظن فيه؟
هذا الهاجس لابد أنه كان يؤرقه, فالمتزمتون
من شيوخ الماضي كثيرون يشعرون بالأرض تنسحب من تحت أقدامهم, والطهطاوي طالع
عليهم من زمنه الجديد. والسلطة القائمة لاتتسامح مع من يحرض عليها أو يشكك في
شرعيتها. والطهطاوي رجل فرد لايملك إلا وظيفته التي انتدبته لها هذه
السلطة, فمما يمكن فهمه أن يجد نفسه مضطرا بين الحين والحين لأن يقدم ماينفي
التهمة ويؤكد الولاء.
إنها اللعنة التي تطارد المثقفين المصريين والعرب أجمعين أن يعملوا لدي السلطة
التي يقاومون طغيانها, ويحتموا بالقوي التي يريدون أن يستقلوا عنها.
غير أن تنازلات الطهطاوي ليست شيئا إذا قيست بانجازاته الباهرة:
لقد سرق لنا النار!
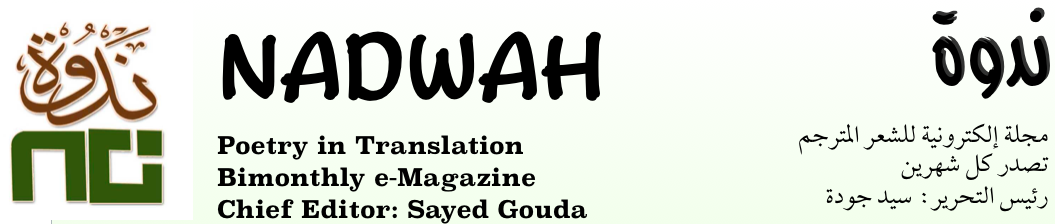 ف
ف

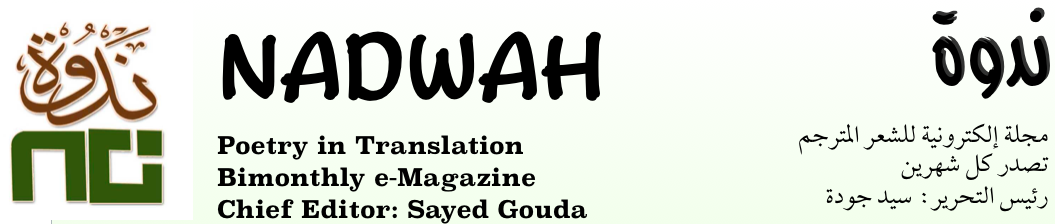 ف
ف
