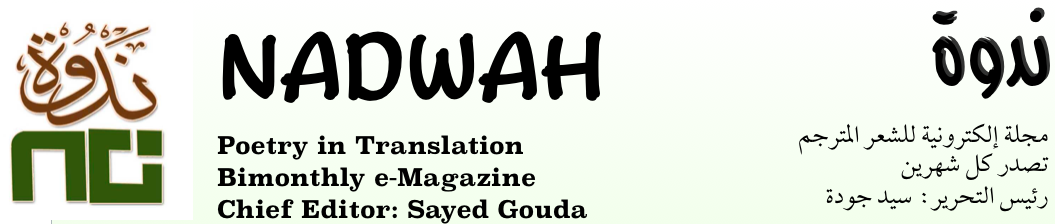 ف ف |
| شعر مترجم |
|
قراءة في واقع ودور المثقفين العرب رامي أبو شهاب - فلسطين للمثقف أثر كبير في تعميق الرؤيا الحضارية للأمة التي ينتمي لها، وغالبا ما تتشكل السيرة التاريخية لأمة ما بناء على خارطة فكرية تكون نتاجا لهذا المثقف الذي يضطلع بدور هام في تعميق القيم والمنطلقات الإستراتيجية التي تتجه لها التصورات الحضارية للأمم والشعوب، وكما عبر غرامشي في سجنه عن مفهوم المثقف ودوره، حيث قال:" إن كل الناس مثقفون، لكن ليس لهم كلهم أن يؤدوا وظيفة المثقفين في المجتمع ". في كتاب سعد البازعي " المكون اليهودي في الحضارة الغربية" يستعرض المؤلف أثر و دور المثقفين اليهود في الحضارة الغربية خلال القرنين التاسع عشر و العشرين، حيث يعاين عددا من المثقفين الذين كان لهم أثر في تشكيل الحضارة الغربية، وكانوا بمثابة قوة موجهة ومؤثرة، وعند استعراض الأسماء التي يدرسها البازعي سنجد سعة في قيمة وأهمية هذه الشخصيات اليهودية، التي تميزت على أكثر من مستوى منها الفكري والفلسفي والأدبي، ومنهم على سبيل المثال اسبينوزا، و كارل ماركس، وفرويد، و دزرائيلي الروائي والسياسي البريطاني، وغيرهم الكثير. مما لا شك فيه أن ثمة قاسم مشترك واحد بين هؤلاء المثقفين، و هو قدرتهم على إحداث فرق وتغيير في البينة الفكرية والحضارية للغرب أو لأوروبا تحديدا، وقد جاءت هذه الحصيلة نتيجة أزمة تمثلت بالإشكالية العرقية و الدينية التي عانى منها اليهود في أوروبا لقرون خلت، حيث تعرضوا للإقصاء والتهميش والنبذ، إلى درجة بات المسمى اليهودي مثارا لنقمة الآخرين، ونتيجة لذلك تضخمت مشكلة الذات والوعي بها، و إدراك ما لهذه الذات من حساسية ضمن الإطار العام للثقافة الأوروبية، فتولدت ردود فعل بطرق عدة؛ منها محاولة الاندماج والذوبان في الآخر؛ ونعني الأوربي، وهناك من حاول التعالي عبر إبراز هذه الذات وتميزها وتفردها، وهناك من توصل إلى حلول سياسية كما حصل مع الحركة الصهيونية بقيادة هرتزل. وهكذا نتج من هذا الأزمة حراك عنيف نحو التعبير عن الهوية، ومحاولة إدراجها ضمن السياق الذي يسمح لها بالظهور والتطور والتعالي، وبالتالي على البقاء، ولم يكن هذا ليتأتى لولا النسق الانتمائي الممارس لبنية عرقية ودينية وثقافية، بغض النظر عن درجة تلون هذا الانتماء، من اللون المائي إلى اللون الغامق، ولكن هذا الانتماء كان دافعا للاستثناء والتميز في سبيله خلق ذاته . جميع الشعوب تبحث في مثقفيها عن خلاصها و مستقبلها، وعن صورتها المتميزة التي تتبدى فيها هويتها وتراثها ولغتها، فالمثقف هو الوعي الحاضر، وهو القادر على قيادة عجلة التحديث والارتقاء الفكري الحضاري. وقد تعمق إدوارد سعيد المفكر والناقد الفلسطيني في بحث دور المثقف في كتابه " صور المثقف "، الذي يلقى الضوء فيه على العلاقة بين المثقف والسلطة، وقدرة المثقف على أن يكون وفيا لأفكاره ومعتقداته ورؤيته، بعيدا عن ذاتيته ونرجسيته وسلطة المؤسسة،التي تعمل مجتمعة على تكبيل الهدف الذي يسعى المثقف إلى تحقيقه ألا وهو الانحياز لقيم الحق والعدالة. يسوق لنا إدوارد سعيد مشكلة المثقفين ومقدار التزامهم من منظور " جوليان بندا " الذي يدين محللا تنازل المثقفين عن سلطتهم الأخلاقية لمصلحة ما يسميه في تعبير تنبؤي " تنظيم العواطف الجماعية " كالروح الطائفية، والمشاعر الجماعية، والعدوان القومي، والمصالح الطبقية ". ولعل إعجاب سعيد ببعض المثقفين كغرامشي الإيطالي، و ميشيل فوكو الفرنسي، وفيكو، ينبع نتيجة لشجاعة هؤلاء المثقفين على أن يكونوا متساميين على ذاتيتهم ومتطلعين إلى منظور حقيقي في كشف أنساق من النشاط الإنساني غير السوي، بالإضافة أيضا إلى تجاوز التقاليد الفكرية، وكسر قيود السلطة التي تعمل على الحد من تحليق الفكر المصاب بالنكوص الذي يؤدي بدوره إلى حالة ضمور في البنية الثقافية للأمة وإبداعها و تأثيرها، وبالمحصلة فإنها ستبقى في حالة السكون دون تقدم في المخطط البياني للحضارة الإنسانية. وإذا ما تعرضنا للمثقفين العرب في القرنين المنصرمين، فإننا سنقع على صورة شوهاء لحالة المثقف العربي، ولاسيما قدرته على تصور حلول ناجعة لأزمته الفكرية والحضارية، حيث سقط المثقف العربي في فخ ما حذر منه إدوارد سعيد سابقا، فبدا المثقف العربي عاجزا وعقيما وغير قادر مواجهة التحديات التي تحيل بينه وبين الانحياز لقيم العدالة والحق والحرية، ومنها على سبيل المثال خضوع المثقف لهيمنة المؤسسة سواء كانت سلطة سياسية أو أكاديمية أو تجارية عبر ارتهانه لعدد من القيود كالتخصص أو الاحترافية و التي بدورها تعود بعائد مادي يضمن له وضعا آمنا مستقرا , ويمكن أن نضيف لواقع المثقفين العرب نزوح معظمهم لحل أزمة الثقافة العربية و دورها الحضاري عبر التماهي في الآخر وانطلاقا منه، و هذا يعني عدم امتلاك رؤية خاصة تتجاوز مرجعيات الآباء المعلمين، ونعني هنا تحديدا الثقافة الغربية حيث نسقط في موجة من المثقفين الذين تتلمذوا على التوجه نحو الغربي عبر اجترار مقولات وأفكار ورؤى لا تمت بالإبداع والأصالة بصلة، وغالبا ما ينحون نحو التقليد والتعبية على اعتبار أنهم تتلمذوا ضمن البنية المتعالية أي الأوروبية، فأصبحت المقدرة على الرطانة باللغات الأوربية تخولهم التخلي عن منظومة فكرة ثقافية عربية عميقة، إلى حد التمني بأن تتحول بعض الرقع العربية إلى أجزاء من القارة الأوربية بحجة التمدن والتحضر والتقدم كما كانت رغبة طه حسين وغيره. إن القراءة في واقع المثقفين العرب تبعث على السخرية، ولاسيما الأعلام منهم، فهم ساقطون في ظلال الآخر، وهم متشرنقون بنمط شوفيني يعاني من جرثومة التعالي الممجوج بما يحملون من صكوك التميز التي تُمنح لهم من سادتهم الغربيين أو سلطة المؤسسات الرسمية ، وهنا نقع على نماذج من المثقفين العرب يقودهم نهج التعالي والهدم للثقافة المحلية، والدعوة إلى التمثل بمنظور الغربي على اعتبار أنه الخلاص، وهذه الفئة هي الأعظم على اختلاف توجهاتها، فهناك من يرى أن الثقافة العربية لا يمكن أن تجد ذاتها إلا إذا أردت الطربوش الغربي وتخلت عن أصالتها وهويتها، وهناك من هم على العكس تماما ينحون نحو الظلامية والانغلاق، الأول يرى أن الأمة والثقافة العربية في طور الانقراض، وأنها قد أصبحت عقيمة، والثاني يرغب في تكبيل الزمن بسلاسل حديدية، فيبقى أسيرا صورة رومانسية تلاشت وغابت. لا مندوحة لنا من الإشارة إلى أن بعض المثقفين العرب مصابون بحمى التغربن، وبروز عشق الذات على اعتبار أنهم أصبحوا ربيبي ثقافة متنورة، وعلى كل من يرغب في الخروج من الأزمة التمسك بأذياله، وهو يصعد نحو الخلاص المتأتي من النموذج الغربي، أو من عبقريته الفذة مع أنه يغض النظر، أو لا يسمح له بأن يرى نماذج أخرى حققت تطورها الحضاري دون أن تذيب لحم وجهها كي يصبح شبيها بالآخر، وهنا نستحضر النموذج الآخر من المثقفين العرب الذي انبثقوا من صميم الثقافة الغربية، ومع ذلك لم يكن نتاجهم الثقافي إلا شكلا من أشكال انتمائهم واعتزازهم بثقافتهم على بعدهم عنها جغرافيا أحيانا، زيادة على ذلك فقد قاموا بتوجه عكسي تمثل بمقارعة الغرب في عقر دارهم، ومع ذلك فقد ظهروا دائما كمثقفين حقيقية مؤثرين في الفكر الإنساني والكوني وغير خاضعين لقيود مؤسسية أو سلطوية ، وهنا نقع على نموذجين واضحين كما لدى المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي، الذي كان ذا طرح فكري أصيل، حيث بحث في مفهوم الهوية و الثقافة، وعمل على بناء تصور فكري نهضوي يعمل على الاستفادة من الاتجاهات السياسية والفكرية، وقد تعملق وحفر عميقا في تحديد مفهوم الثقافة ومشكلتها عبر عدد من المؤلفات الهامة كمشكلة الثقافة ومؤتمر باوندنغ، و كما هو أيضا إدوارد سعيد المثقف الفلسطيني الأميركي الذي اضطلع بدوره كمثقف عالمي مؤسسا خطابا يكشف عن الممارسات الامبريالية الغربية، ويقرأ واقع الاسشتراق الذي اصطنع صورة للشرق عبر النصوص والخطاطات التي وضعها الغرب، وهو في كل أعماله وكتبه كان دوما منحازا إلى قيم الحرية والعدالة، وإلى مرجعياته العرقية و الثقافية، والطريف في الأمر أن كلاهما كان يكتب بلغة أوروبية، ولنا في عدد من مثقفي العالم نماذج تبين دور المثقف الحقيقي الذي لا ينتقص من ذاته ومرجعيته و هويته الجماعية أو الكلية، كما هو لدى فرانز فانون، وسنغور وإيمي سيزاز، و هومي بهابها و نفوجي واثغيونغو وغيرهم من الكتاب . إننا هنا على مفترق طرق في قراءة حركة المثقف وإشكاليته، ولعل الطريق يقودنا إلى قراءة وتقصي أساب تراجع الثقافة العربية التي لا يمكن أن تنقرض أو ينقرض منتجوها، فالسبب يعود وبشكل واضح وبسيط إلى فشل جميع التوجهات التي اتخذت من الاحتذاء و التماهي بالمركزية الغربية أو التمركز في بنية تاريخية ومحاولة اجترارها، أو الركون إلى صوت السلطة والمؤسسة وامتيازاتها المادية و النخبوية .... فكيف يمكن أن نفسر تراجع الدور الحضاري العربي والثقافي والسياسي والاقتصادي على الرغم من كل التوجهات التي نقوم بها في محاولة الاستفادة من كل الأساليب والوسائل والسياسات والقيم الغربية، والتي لا تعود إلا بالمردود السلبي. ولعل المتتبع لواقع الأمة العربية سيدهش حين يعاين حال الأمة العربية التي كلما تمثلت النموذج الغربي وقد تفاقمت أزماتها وضعفها، فحالنا قبل عشر سنوات أفضل من الآن، وحالنا قبل عشرين عاما كان أفضل وأقل مأساوية. هذه العلاقة باتت شبه قاعدة مطردة، فكلما أمعنا في الإذعان لمصطلحات ومفاهيم ثقافية ذات صبغة عولمية تدعو إلى التماهي الغربي ازدادت قضايانا الإنسانية والسياسية الحضارية سوءا، إن هذا الانبهار في الآخر ومحاولة أن تختلق صورتك في مرآته ما هو إلا دلالة ضعف وعدم قدرة على فهم الذات والظرف حقا، إن العديد من الدول قد نهضت ووضعت نفسها في البنية الحضارية الفاعلة، و لم تلتفت إلى النموذج الغربي ولأن مثقفيها باتوا على الضفة الأخرى من الركون السلطوي ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: الصين ودول أمريكا اللاتينية .... التي عرفت ذاتها وأدركت قدرتها دون أن تضطر إلى مسخ لغتها وهويتها. إن الانقراض الذي يأتي به البعض ما هو نتيجة لتوجهاتهم العقيمة نحو ارتداء قناع، يبدو أنه لا يرغب في أن يكون متوفرا على الوجوه، و على تيقن من أنه يرفض التضاريس ويرفض اللون ويرفض اللسان، إن الثورة على سلطة ما، يعني حقيقة انتماءك لفضاء ورؤية أخرى وصوب قيم جديدة، فأنت هنا تتخلص من الآلهة، ولكن تبدو المشكلة حين تتبنى آلهة جديدة لها أهدافها، هذا ما عانت منه الثقافة العربية ومثقفوها حين ثاروا على سلطة وبينة ثقافية، ولكنهم سقطوا في ظل تبني المنظور الآخر والمضاد، وسلطة أخرى، ونعني هنا المنظور الغربي أو الموروث الرومانسي ، وهنا فقدوا أهم ميزة للمثقف وهي الحياد والتحرر من تبني وسلطة مرجعيات ما، إنها الضلالة والعمي، فالمثقفون العرب لم يحملوا معم سوى جرثومة الفناء التي تضخمت لديهم كما تضخمت ذواتهم حتى باتوا يستعلون على مرجعيتهم الثقافية والحضارية حيث يستبدلون آلهة بأخرى.
|
|
|
|
 |
 |
|
|
