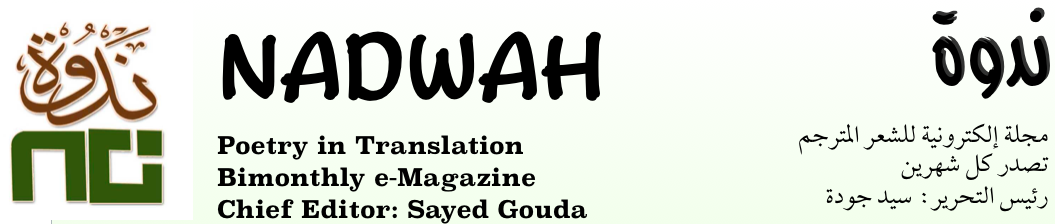 ف ف |
| شعر مترجم |
|
إدوارد سعيد - فلسطين ترجمة: صبحي حديدي عند درويش يدخل الخاصّ والعامّ في علاقة قلقة دائمة، حيث تكون قوّة وجموح الأوّل غير متلائمة مع اختبارات الصواب السياسي، والسياسة التي يقتضيها الثاني. ولأنه الكاتب الحريص والمعلّم الماهر، فإن درويش شاعر أدائي من طراز رفيع، ومن نمط لا نجد له في الغرب سوى عدد محدود من النظائر. وهو يمتلك أسلوباً ناريّاً، لكنّه أيضاً أسلوب أليف على نحو غريب، مصمّم لإحداث استجابة فورية عند جمهور حيّ. قلّة قليلة من الشعراء الغربيين ـ من أمثال ييتس Yeats وولكوت Walcott وغنسبرغ Ginsberg ـ امتلكوا ذلك المزيج النادر الآسر الذي يجمع بين الأسلوب السحري التعويذي الموجّه للجماعة، وبين المشاعر الذاتية العميقة المصاغة بلغة أخّاذة لا تُقاوم. ودرويش، مثل أقرانه الغربيين القلّة، فنّان تقني مدهش يستخدم التراث العروضي العربي الفنّي والفريد بطرق تجديدية وجديدة على الدوام. ذلك يتيح له أن ينجز أمراً بالغ النُدرة في الشعر العربي الحديث: براعة أسلوبية فائقة وفذّة، ممتزجة بحسّ بالعبارة الشعرية يجعلها أشبه بالمنحوتة بإزميل، بسيطة في نهاية الأمر لأنها بالغة الصفاء. قصيدة «أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي»، المترجمة في هذا العدد، كُتبت ونُشرت في عام 1992. ولقد انبثقت من سياق مناسبات متباعدة: الذكرى الـ 500 للعام 1492 [سقوط غرناطة، ورحلة كولومبس إلى أمريكا]، سفر درويش إلى إسبانيا للمرّة الأولى، وأخيراً قرار منظمة التحرير الإشتراك في عملية السلام تحت رعاية روسية ـ أمريكية وانعقاد مؤتمر مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) 1991. والقصيدة نُشرت أولاً في صحيفة «القدس العربي»، اليومية الفلسطينية التي تُحرّر وتُطبع في لندن. والحقّ أن هذه المقطوعات الشعرية تنطوي على نغمة الكلل وهبوط الروح والتسليم بالقدر، والتي تلتقط ـ عند العديد من الفلسطينيين ـ مؤشّر الانحدار في أقدار فلسطين التي، مثل الأندلس، هبطت من ذروة ثقافية كبرى إلى حضيض فظيع من الفقد، على صعيد الواقعة والإستعارة معاً. لكنّ ما يمنح القصيدة تجانسها الفنّي ليس طبيعة موضوعها بقدر وجهة توسيعها للطَوْر الأكثر راهنية في شعر درويش، نحو مواقف جديدة وتصوير جديد، الأمر الذي تلتقط هذه الترجمة الممتازة قدراً كبيراً منه. ومنذ أن غادر درويش بيروت عام 1982، وموضوعات شعره الرئيسية لا تدور حول مكان وزمان النهاية (حيث الإشارة الملحّة المتكرّرة إلى مختلف المنافي الفلسطينية) فحسب، بل حول ما سيحدث بعد النهاية، وهيئة العيش عبر زمان المرء ومكانه، وكيف يصبح اللقاء بعد الخاتمة موقفاً منفرداً وإكزوتيكياً دون ريب، يقتصر على الشاعر وشعبه. وفي عام 1984 كتب يقول: «تضيق بنا الأرض، تحشرنا في الممرّ الأخير»، وتابع: .. ورأينا وجوه الذين سيرمون أطفالنا وفي «أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي»، لم تعد الأرض والأعداء وراء التحكّم بالقضية وحشر الشعب نحو النهاية. الآن جاء دور الـ «نحن» والقَدَر، كما يتمثّل في سقوط غرناطة عام 1492، وهنا المسؤولية. والشعر اليوم يستبدل التاريخ كموقع للحدث، تماماً كما في قصيدة والاس ستيفنز Stevens «عن الوجود الصرف»: النخلة عند نهاية الروح، لكن انسحاب درويش في هذه القصيدة ليس شبيهاً بانسحاب ستيفنز في الأبيات السابقة، أو ييتس في «الإبحار صوب بيزنطة». الشعر عند محمود درويش لا يقتصر على تأمين أداة للوصول إلى رؤية غير عادية، أو إلى كوْن قصيّ من نظام مُتعارف عليه، بل هو تلاحم عسير للشعر وللذاكرة الجمعية، ولضغط كلّ منهما على الآخر. والمفارقة تتعمّق على نحو لا يُحتمل حين تُناط خصوصية الحلم بواقع فاسد مهدد، أو تتمّ إعادة إنتاجها بفعل ذلك الواقع تحديداً، مثلما يحدث في القسم الحادي عشر من القصيدة، حين ينهار الجدل القلق بفعل تكرار كلمة «كمنجات»، دون أن يُحلّ التلاحم أو يُرتقى به. هذه السمة المشدودة; أو المعلّقة عن سابق عمد في شعر درويش الراهن، تجعل من ذلك الشعر نموذجاً على ما أسماه أدورنو Adorno بـ «الأسلوب المتطاول»، حيث التقليدي والأثيري السماوي، التاريخي والجمالي المرتقي، تمتزج جميعها لتقديم حسّ ملموس بالغ بما يجري وراء أمر لم يسبق لأحد أن عاشه في الواقع الفعلي. * * *
القدس العربي
|
|
|
|
 |
 |
|
|
